كنتُ جالسًا على أحد شواطئ أبحر الرملية، أحتسي قهوة قصيمية، وأترك للوقت أن يمرّ بلا مقاومة. في البعيد كان الشباب يمرحون بالدبابات البحرية، يقطعون صفحة الخليج ذهابًا وإيابًا، أما النوارس فكانت تفعل ما اعتادت عليه منذ دهور؛ تحلّق، تهبط، تلتقط صيدها، ثم تعود للطيران.
لفت نظري نورسٌ منها؛ كان يسرع في طيرانه ثم يبطئ فجأة، يوقف رفرفة جناحيه ويمدّهما، وينساب في هواء البحر من جديد. وفي تلك اللحظة تحديدًا، رأيته يحكّ ذقنه بإحدى قدميه، فعلٌ صغير، غير متوقع، لا يتناسب مع فعل الطيران الأسطوري.
ربما لم أكن لأنتبه إلى هذا المشهد قبل أسابيع. كنتُ آنذاك أحمل عينًا أخرى، عينًا تُفكّر في الصورة قبل أن تُلتقط، وفي التعليق قبل أن يُكتب، وفي اللايك قبل أن يصل. منذ السابع عشر من ديسمبر، وأنا بلا حساب على إنستغرام، آخر حسابٍ عام ونشطٍ لي على منصات التواصل الاجتماعي. حذفتُه اضطرارًا، كنتُ أفكّر في توقّف طويل لكنه مؤقت، ثم اكتشفتُ أني لا أنوي العودة. أن شوقي لحياتي الافتراضية، رغم صدقه، لم يعد كافيًا ليقنعني بأنها الحياة التي أريد أن أُكمل بها، أُريد حياةً تُلمس باليدين.
أبقيتُ على تويتر وفيسبوك لأغراض مهنية بحتة، أطلّ عليهما من المتصفح على الآيباد، مرة واحدة في الأسبوع. احتفظتُ بحساب عائلي على سناب شات للتواصل، وحساب على تلغرام لمتابعة قنوات الكتب وبعض كتابات الأصدقاء.
تصادف قراري مع قراءتي لكتاب “فلسفة التجرد الرقمي“، للكاتب الذي صار كاتبي المفضل كال نيوبورت، وكان الكتاب قد مر عليّ حين صدرت ترجمته أول مرة، فزهدت فيه، حتى إذا قرأت كتابه “عملٌ عميق” أول هذا العام. طفقت أبحث عن كتابه فلسفة التجرد الرقمي، فلم أصل إليه إلا مع آخر العام، حين زودني به الصديق ورّاق، بعد أن أعياني البحث عنه، فقد توقفت الدار عن طباعته.
والكتاب في جوهره ليس مجرد طرح حول التعامل الأمثل مع منصات التواصل الاجتماعي كما توقعت، ولن تجد فيه خططًا للتوقف المؤقت، أو الحمية السوشلية، بل هو بيان فلسفي يهدف لإعادة تعريف علاقتنا بالحياة من خلال لحاظ تأثير التقنية عليها.
لست أحاول هنا تقديم مراجعة متكاملة للكتاب، لكن الفكرة الأساسية هي استعادة حياتنا من براثن التقنية عمومًا، لا منصات التواصل الاجتماعي فقط، وإعادة وضعها في إطار “الدعم اللوجستي للحياة”، من خلال طرح سؤالين على أي تقنية نتعامل معها: هل استخدامي لهذه التقنية يعزز قيمةً عليا أُقدّرها؟ وهل هذه التقنية هي أفضل وسيلة لتعزيز هذه القيمة؟ إن كانت الإجابة نعم، فعليك وضع مجموعة من الإجراءات التشغيلية لاستعمال هذه التقنية في حدود “الدعم اللوجتسي” فقط.
يُقدّم المؤلف عشرات الأمثلة والتطبيقات لعناصر فلسفته في التجرد، مما يُمكنك من إعادة تصميم بعضها لتناسب حياتك، وهي بكل صراحة عملية وممكنة، مهما ظننت أنك لا تستطيع التخلي عن هذه المنصات، والكتاب عمومًا في أكثره ليس عن التقنية، بل عن الحياة بعيدًا عنها، كيف تقضيها؟ ومع من؟
من المفاهيم التي يركز نيوبورت عليها في كتابه مفهوم “العزلة” والتي يستعير في بيانها تعريفًا مدهشًا، كحالة ذهنية يخلو فيها العقل من التفاعل مع عقول الآخرين، والتي أجدها غالبًا حين أجلس لتدوين يومياتي في كتابي الأسود الذي سأحدثكم عنه يومًا ما.
وحين جلستُ مع غياب آخر شمسٍ في العام المنصرم، أقلّبُ صفحات ما دوّنته في ذلك الكتاب طوال عام 2025م، استوقفتني ملاحظتان فلتتا من قيود “عادية الحياة”، والكتابة عن المشاعر، وتفاهة الأحداث الرتيبة التي تغرق فيها الأيام عادةً. شعرتُ أن فيهما ما يخرجهما عن سياق التدوين الخاص، ويجعلهما جديرتين بأن أشاركهما معكم.
أما الأولى، فقد دونتها بعد لقاءٍ جمعني برجلٍ معروف، يقف خلف مبادرةٍ ذات أثرٍ واسع. ذهبتُ للقائه في إحدى مقاهي جدة بكامل حماسي، خاصة وأنه هو من طلب الاجتماع بي. أمضينا قرابة الساعتين، خرجتُ منهما بفكرةٍ دونتها في كتابي الأسود عن نوعين من الرجال في الحياة المهنية، أو خارج دوائر الصداقة والقرابة والزمالة عمومًا، إذ وجدتُهم على نوعين:
النوع الأول: رجلٌ يتقن فن التظاهر، يمنحك انطباعاً زائفاً بالاهتمام عبر حيلٍ ذهنية بارعة، بينما عقله يسبح في ألف وادٍ غير الذي تسلكه معه. إنه يشبه في تفاعله “شات جي بي تي”؛ يُحسن التجاوب مع أي سياق، ويصوغ لك كلاماً يبدو في ظاهره قيّماً، لكنه في حقيقته خواءٌ تافه لا روح فيه. اللقاء بهذا النوع سهلٌ ومتاح، لكنه مرهقٌ للروح، وتجد نفسك تواقاً لانتهاء الساعة التي تقضيها معه، ففائدته لا تتجاوز حدود الاستفادة من علاقاته العامة.
النوع الثاني: رجلٌ يتفرّغ لك بكيانه، يمنحك إصغاءً مذهلاً يُشعرك بقيمة الوقت الذي يمضي بينكما. إذا تحدث، نطق بعمقٍ مدهش في دوائر اختصاصه، وإذا خرج الحديث عن حدود خبرته، أحالك بتواضع العارف إلى من يثق بعلمهم. هذا النوع نادرٌ وصعب المنال، الجلسة معه ساحرة، تود لو أن عقارب الساعة تتوقف لئلا تنتهي.
كان الرجل الذي قابلتُه ينتمي للنوع الأول.
أما الملاحظة الثانية، فكانت وليدة جلسة أُنس جمعتني بالصديق عبد العزيز التركي. كنا نحتسي “الأتاي” الموريتاني ونحن نتابع مباراة الذهاب المثيرة بين برشلونة وإنتر ميلان في نصف نهائي أبطال أوروبا؛ حينها سألتُه عن فلسفته في الإدارة، فجاء رده بما لا يتناسب مع صخب المباراة وسرعتها، وإن كان يلائم الأتاي في إعداده وشربه.
قال لي عبد العزيز إنه إنسانٌ بطيء في العمل، وأنه يحب هذا البطء ويحتفي به. فلسفته تقوم على كسر حاجز التردد أولاً، فيبدأ المشروع سريعاً وبلا تسويف، لكنه بمجرد أن يشرع في التنفيذ، ينتهج وتيرةً هادئةً ومتأخرة. شبّه لي الأمر بـ “الطبخ”؛ إذ يتساءل: ما الذي يمنعك من البدء في إعداد وجبتك الآن؟ ولكن، إذا بدأت فعلاً، فما الداعي للعجلة؟ فالطبخ، كالإدارة، كالحياة، يحتاج للنار الهادئة لكي تنضج المكونات جيدًا، وتكتسب نكهتها اللذيذة.
فلسفة عبد العزيز في “البطء”، و”تجرد” نيوبورت من التقنية، و”حضور” النوع الثاني من الرجال؛ هي القواعد التي أعتزم بها هندسة أيامي القادمة، لذا وأنا أطوي صفحات العام، لا أطلب أكثر من تمثّل ذلك المشهد الصغير، أن أمنح نفسي الحق في أن أحكّ ذقني وأنا أطير، أن أتوقف عن تلك الرفرفة المحمومة التي استنزفتني، أن أبسط جناحيّ للريح، منساباً في سمائي بلا استعجال، وحاضراً في لحظتي بلا ادّعاء، ومكتفياً بمتعة الوجود في المدى .. حتى لو لم تكن أجنحتي تصفق لهذا العالم طوال الوقت.
اكتشاف المزيد من دفاتر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
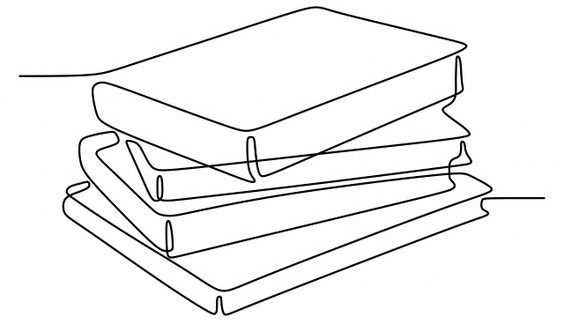
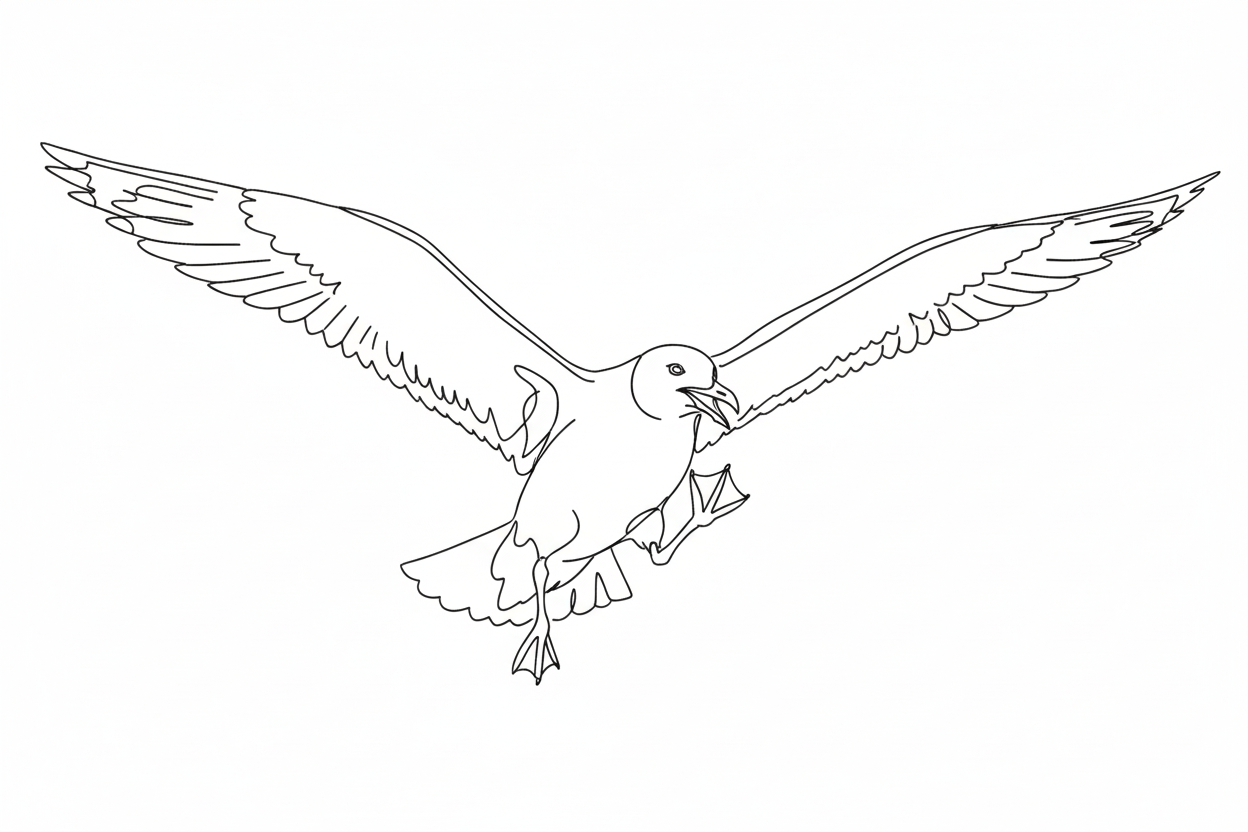
جميل يا حسان. تمنياتي لك بنتيجة ترضيك.
إعجابLiked by 2 people
الله يرضيك راضي .. تسلم.
إعجابإعجاب
عام سعيّد عليك أستاذ حسان..
مليئ بالبطئ، البساطة والطمأنينة دائمًا، كل التوفيق (؛
إعجابLiked by 1 person
علينا وعليكم، أجمعين يارب .. شكرًا هيفاء.
إعجابLiked by 1 person
رائع جداً
إعجابLiked by 1 person
تسلم
إعجابإعجاب